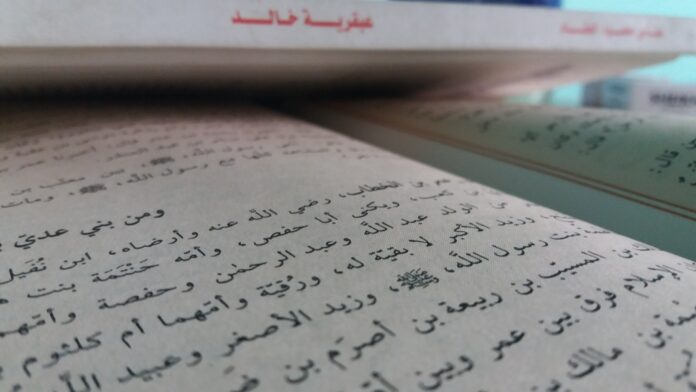قال في لقاء تلفزيوني مسجل ” بالنسبة لي 70% من تفسير القرآن أنا أرميه في القمامة” ويقصد التفاسير التي كتبت في القرون الأولى للإسلام ودعا لإعادة تفسير القرآن ووصف نفسه ومن مثله “نحن أعلَم منهم” أي أكثر علماً من أولئك الذين فسروا القرآن في القرون الماضية.
ولن أذكر اسم عضو مركز تكوين المقصود في الفقرة أعلاه لأن الموضوع لا يتعلق بشخصه، حيث أنني في هذا المقال وبصفتي شخص درس اللغة دراسة أكاديمية ومارسها مهنيا عشرات السنين سأناقش الموضوع من وجهة نظر علمية ومهنية ولغوية بحتة.
ما هي لغتنا الأم؟
وفي البداية قد يكون من الضروري الاستشهاد بحادثتين تاريخيتين ستكونان أساساً للسؤالين الجوهريين في هذا النقاش: هل اللغة العربية لغتنا الأم؟ لماذا هذا السؤال مهم في موضوع تفسير القرآن؟
الحادثة الأولى من القرن السابع الميلادي وقد وردت في مصادر كثيرة نختار منها تفسير القرطبي الذي ورد فيه في سياق تفسير الآية الكريمة “الله فاطر السماوات والأرض” الآتي:
“قال (عبد الله) ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرٍ، فقال أحدهما : أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها.
أي أن ابن عباس الذي كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش في صدر الإسلام وهو من هو في العلم حتى أنه يلقب بـ “ترجمان القرآن” لم يفهم كلمة “فاطر” فهماً صحيحاً إلا عندما سمع تفسيرها من أعرابيين- والأعرابي هو العربي البدوي الذي يعيش في الصحراء ولا يعيش في المدن وهذا يعني أن أهل مكة والطائف وكافة مدائن جزيرة العرب لا يسمون أعراباً.
ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه حتى في ذلك الزمان عندما كانت اللغة العربية الفصحى هي اللغة المحكية كانت لغة حضر العرب ليست بنفس مستوى النقاء الذي اتسمت به لغة البدو منهم.
أما الحادثة الثانية فهي حادثة حديث “الرويبضة” التي حدثت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي سأله فيها الناس عن معنى الكلمة وفسرها لهم النبي فقد كان يتمتع بلغة عربية رفيعة لأنه قضى ردحاً من طفولته في البادية.
كانت العرب من سكان الحضر ترسل أبنائها إلى البادية ليتعلموا العربية الصحيحة غير الملوثة بمفردات أجنبية كما هو الحال في المدن التي تتفاعل مع العالم الخارجي باستمرار مما يؤدي إلى دخول كلمات أعجمية على اللغة العربية لعرب المدائن.
وبناءاً على ما تقدم فقد صار مشروعاً أن نتساءل ونقول: إن كانت اللغة العربية لحضر العرب في القرن السابع الميلادي تفشل في مجاراة وفهم واستيعاب السياقات الصحيحة لبعض الكلمات العربية التي يستخدمها بدو الجزيرة العربية فكيف الحال بعرب هذا الزمان؟
لغة المدارس
علينا أن نعترف بأنه من الناحية العلمية فإن اللغة العربية هي ليست اللغة الأم لمواطني الدول العربية وعرب الأقاليم اليوم لأن اللغة الأم كما يستدل من اسمها هي اللغة التي يتعلمها الطفل من أمه أو من البيت الذي ينشأ فيه ولعل من أبلغ الأوصاف للغة الأم ما جاء على لسان الحارث بن كلدة في خطابه أمام كسرى الفرس حيث وصف لغة أهله العرب بالقول: يمرق من أفواههم الكلام مروق السهم من نبعة الرام أعذب من هواء الربيع وألين من سلسبيل المعين.
وهذا يعني أن اللغة الأم هي اللغة التي تخرج من فم المتحدث مرتبة بدون تفكير ولا تدبير، وهذا ليس حال من يتحدث العربية اليوم فالأغلبية الساحقة من الجماهير العربية اليوم لا تستطيع التحدث بالعربية الفصحى بطلاقة وبدون لحن وعليه فإن اللغة العربية هي اللغة الأولى لمواطني الدول العربية وعرب الأقاليم في هذا العصر ولكنها ليست لغتهم الأم وأسباب ذلك كثيرة نخص منها سببين إثنين:
الأول، أنهم يتعلمونها في المدرسة تعلماً وعليهم أن يحفظوا قواعدها وإن لم يمارسوها فسيكون مصيرها النسيان مثلها مثل أي لغة أجنبية يتعلمها المرء وينساها إن لم يستخدمها، وما على المرء سوى أن يلقي نظرة على ما يكتب الناس في وسائل التواصل الاجتماعي ليدرك مدى ضعف المواطن العربي في اللغة العربية، بينما في المقابل لا يوجد عربي ينسى لغته العامية أو يخطئ في قواعدها حتى لو تاه في جزيرة غير مأهولة مائة عام فلن ينساها لأنها ببساطة لغته الأم التي تعلمها من أمه!
والثاني، إن اللغة العربية التي يتعلمها عرب اليوم في المدرسة هي عربية مبسطة ومشوهة ومليئة بالتراكيب اللغوية المنقولة من اللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية بالدرجة الأولى، وهي أضعف من أن تكون رافداً حيوياً لمساعدة المرء في فهم معاني كلمات القرآن وفهم سياقاته اللغوية.
لذلك نرى أن غالبية العرب اليوم وحتى المتعلمين منهم وبضمنهم أولئك الذي يخاطبون الجمهور من فنانين وصحفيين وما شابه لا يستطيعون التحدث بدون لحن ولا يستطيعون الكتابة دون تصحيف، فكيف يمكن أن يأتمنهم المرء على تفسير صحيح للقرآن، قمة اللغة العربية التي ما بعدها قمة؟!
إن التفسير كعملية لغوية علمية هي نوع من أنواع الترجمة وهي فعلا كانت تسمى “ترجمة” في العصور السابقة، والترجمة توصف أكاديميا على أنها مزيج من علم وفن ومن أهم أساسيات عملية الترجمة هو اتقان المترجم للغة المصدر واللغة المستهدفة على حد سواء.
وبما أننا أسسنا لحقيقة أن عرب اليوم لا يمكنهم أن يتقنوا لغة الأعراب في القرن السابع الميلادي لأنها ليست لغتهم الأم ولا يمكنهم حتى دراستها دراسة ميدانية لأنها غير متداولة اليوم حتى موطنها الأصلي فإن محاولتهم ترجمة وتفسير نصوص القرآن بدون الاستناد للتفاسير السابقة سينتج عنه في الغالب عوار شديد!
عجوز بني إسرائيل
ولعله من المهم إعطاء برهان حيوي على ما تقدم من حادثة وقعت في منذ زمن غير بعيد وتحديداً في النصف الثاني من القرن الماضي وبطلها عالم من علماء الحديث وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
فقد واجه الشيخ الألباني خلال عمله في تنقيح الأحاديث النبوية معضلة لغوية أثناء تناوله حديث عجوز بني إسرائيل التي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ضمن ما قال في سرد القصة أن بني إسرائيل سألوا امرأةً يهودية طاعنة في السن عن مكان “عظام يوسف” أي النبي يوسف عليه السلام.
يقول الألباني: كنت استشكلت قديما قوله في هذا الحديث: عظام يوسف ـ لأنه يتعارض بظاهره مع الحديث الصحيح: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ـ حتى وقفت على حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن، قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله، يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى، فاتخذ له منبرا مرقاتين.
ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الألباني الذي كرس عمره كله لدراسة الحديث لم يستطع أن يفسر كلمة “عظام” في سياق معين إلا بعد أن وصل لحديثٍ آخر فسر له السياق الصحيح للكلمة وهي أن كلمة عظام في سياقات معينة في لغة العرب في القرن السابع الميلادي كانت تعني “الجسم” أو “جثة الشخص”.
ولكن ورغم كل ما تقدم فإن محاولات تفسير القرآن لم تتوقف عبر العصور وحتى في يومنا هذا فمن حيث المبدأ لا يوجد قانون يمنع تفسير القرآن ويمكن لعضو مركز تكوين أن يقدم نتاجه ولكن لن يستطيع أن يلقي بجهد من سبق”في القمامة” حتى وإن أراد!
أما بخصوص عبارة “نحن أعلم منهم” فهو لم يفسر ما هو قصده في ذلك والخوف كل الخوف أنه كان يقصد استخدامنا للانترنت والهاتف الجوال والحاسوب لأن هذه كلها لا تصبح علماً إلا إذا اخترعها المرء بنفسه أما استخدامها فلا يسمى علما بل هو مجرد “مهارات مكتسبة”!